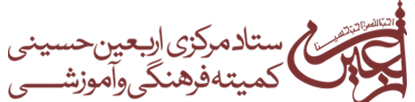تحدث الأستاذ حسن رحيم بور أزغدي في إحدى محاضراته عن ملحمة عاشوراء وقراءات المدارس المعاصرة تجاهها، وفيما يلي نقدم لكم نص المحاضرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملحمة عاشوراء وقراءات المدارس المعاصرة … عرض و نقد
بتعاليم الإمام الحسين ننتصر
يقولُ أنصار مدرسة أهل البيت عليهم السلام: إنهم قد دوَّنوا واقعة الطف منذُ عصر يوم التاسع من مُحرم إلى ظهر عاشوراء وباتوا ينقلونَ ذلكَ ويطرحونهُ في المجالس كلما سنحت لهم الفرصة. وسَنُعرِّجُ على كربلاء في كُلِّ مقالةٍ وكتابٍ حتى وإن لم يرتبط بالموضوع ونحاول وصلَ كُلِّ شيءٍ بقضية كربلاء ولن نَدَعَ هذه الذكرى تَفوتُ علينا أو ننساها، وباتوا يُخاطبونَ أعداء الإمام على مر التاريخ بالقول: إنكم تُحاولونَ محوَ ذكرى الحسين وثورته لكننا نفعل العكسَ ونُكرسُ ذلكَ في حياة أتباع مدرسة أهل البيت حتى لو اقتضى الأمرُ أن نتظاهر بالبكاء والتألُّم حيثُ تدعو الروايات إلى التباكي حتى ولو لم يكن الإنسانُ مُتأثراً بعد وعليه أن يُطأطأ الرأسَ وأن يضعَ يديه على وجهه وعينيه.
هذه رسالةٌ واضحةٌ وجميلةٌ، وبهذه الصورة حُفِظَت مراسمُ عاشوراءَ والإمام الحسين عليه السلام، لأنَّ الحُكامَ استفادوا من سياسة الترغيب والترهيب لمحو ذكرى الحسين عليه السلام. لأنَّ ذكرى الحسين يعني الثورة على الظلم والحكومة الجائرة، ويعني الثورة ضدَّ الربا والفقر، ويعني محاربة الاستبداد، ويعني محاربة الظالمين والمتكبرين لأنَّ النفاق سيزول ولأن الإمام الحسين عليه السلام ثارَ ضدَّ هذه الأمور. إنَّ لحزب الله في لبنان قناةً فضائيةً تحمل اسمَ (قناة المنار) ويُلتَقَطُ بَثُّها في عموم المنطقة، كان قد وجَّهَ أحدُ المُشاهدينَ الفلسطينيينَ سؤالاً وهم في الغالب من الأخوة أهل السُّنَّة، قد شاهدَ أفلاماً وصوراً عن العمليات الاستشهادية التي نفَّذها مُقاتلو المقاومة الإسلامية، حيثُ يودِّعُ الابنُ أمهُ وتقول هذه الأم لولدها اذهب، وتقول للثاني اذهب. وهذا المشاهد قد شاهدَ العِصابةَ على جبين المقاتل وقد كُتبَ عليها يا حُسين وأمثالُ هذه الكلمات. والفلسطينيونَ كانوا قد استلهموا في انتفاضتهم وعملياتهم الاستشهادية من عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، حيثُ لم يكن معروفاً تنفيذُ مثل هذه العمليات من قبل، فقد بدأها أبناءُ جنوب لبنان ضدَّ القوات الصهيونية، ولذلك استطاعت المقاومة الإسلامية أن تهزم إسرائيلَ لأولِ مرةٍ في تاريخ هذا الكيان، حيثُ لم تتراجع إسرائيل عن أيةِ بُقعةٍ أخرى كانت احتلتها. وهناك الكثير من المناطق التي ما تزال مُحتلة في الضفة الغربية ومصر والجولان السوري، وما اقتطعته إسرائيل من البلدان العربية ما تزال تحتله، وإذا بأحد الفلسطينيين يكتب رسالةً إلى قناة المنار ويقول: هل يمكن للحسين أن يَقْدِمَ إلى فلسطين؟ الحسين الذي حَررَ لبنان. لم يكونوا على إطلاعٍ كاملٍ بقضية الإمام الحسين عليه السلام، نقول لهؤلاء: نعم إنَّ بإمكان فكر الإمام الحسين أن يُحرِّرَ فلسطين شريطةَ أن يتبعوا تعليماته التي ثارَ من أجلها. وهكذا فإنَّ الإمام الحسين خطَرٌ يتهدَّدُ كيانهم لأنَّ ذكرى ثورته تؤرِّقُ الكثيرين، لأنَّ عاشوراء تعني الثورة على الطغيان وضماناً للعدل والإنسانية والكرامة، وعندما يكون الحديث عن الصلابة والصمود فهذا يعني أنَّ الوقوفَ بوجه العدل والكرامة من قبل الأعداء يعني الوقوفَ حتى آخر قطرةٍ من دمائنا، ولذلكَ حاولَ الحكام الجائرون تضييع قبر الإمام الحسين، وفَتَحوا المياهَ على قبره الشريف وحَرَثوا الأرضَ التي تحوي قبرهُ الشريف عِدَّةَ مراتٍ على مر التاريخ لتضييع علائم القبر وحتى يتمَّ نسيان الإمام الحسين لكنَّ الأمر لم يُفلح.
بعدها حاولوا طمسَ حقيقة ما جرى في كربلاء ثقافياً، حيثُ قالوا إنَّ عاشوراء تعني العنف تعني الجهاد تعني استخدام السلاح تعني الحماقة وظلُّوا يُكرِّرونَ هذه المفاهيم المغلوطة إضافةً إلى استخدام وسائل أخرى منها حرق المكان. لقد فشلوا في كُلِّ ما يفعلونه وقالَ أتباعُ مدرسة أهل البيت إنَّ ما حصلَ عبارة عن عارٍ ثَبُتَ في التاريخ ولن يُمحى من صفحة التاريخ ولا يمكنهم غَسلُ هذا العار ولن نسمح لهم بذلك فلا يمكنهم قتل الحسين ومن ثَمَّ تضيعُ الموضوع وكأنَّ شيئاً لم يحصل. إنَّ هناكَ سوءَ فهمٍ وانتهى لن نسمحَ بِتميّعِ الجريمة مهما حصل، وأن تدخلَ هذه الجريمة في سجل التأريخ وكفى، هكذا يقولون، ينبغي رفعُ لواء الجهاد والشهادة والعزَّة والكرامة الإنسانية من خلال قضية الحسين على الدوام ولن نسمح بمحاربة ثورة الحسين ثقافياً أو بغيرها من الطرق.
وفي الجهة المقابلة نرى أنَّ هناكَ تياراً اتَّجَهَ نحو الانحرافِ والتضخيم في واقعة الطف ولو رجعنا إلى التاريخ لرأينا أنَّ الحُكامَ المستبدين على مر التاريخ منعوا زيارة الحسين تارةً، لكنَّ أتباعَ أهل البيت تمسَّكوا بالموضوع رُغمَ معارضة الحكام ورغمَ تعرضهم للأذى والضرب والقتل أحياناً. وعندما شاهدَ حكام الجَوْرِ أنَّ أتباع أهل البيت لن يتركوا شعائر الحسين وزيارته قالوا إذاً نضعُ شرطاً لمن يُريدُ زيارة الحسين يقضي بقطع أطرافه فلم يتراجع الموالونَ لأهل البيت بل شكَّلوا صفوفاً طويلة للزيارة وطالبوا جلاديهم بفعل ذلك لأنهم مُشتاقونَ لزيارة الحسين عليه السلام. هكذا ظلت قضية الحسين حيَّةً في ضمائر الشيعة ولو تلاحظون في إيران إبانَ الحرب المفروضة لم تكن عمليةٌ واحدةٌ من العمليات تُنفَّذُ دونَ ذكر الإمام الحسين أو التوسل به ولن تجدوا وصيةً من وصايا الشهداء ليسَ فيها ذكرٌ للإمام الحسين عليه السلام.
كانَ الأعداء يخافونَ من اسم الإمام الحسين وثورته ومن هذه التطبيقات العمليَّة على الأرض في يومنا هذا وهكذا تبدو ثورة الحسين تُخيف الأعداء، لأنَّ ثورة الحسين علَّمت أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن يقف الثائر بوجه الظلم ولو كلَّفهُ ذلكَ مقتلَ ابنه الرضيع فهو سيأخذُ بدمه ويُلقيه إلى السماء ويقول كما قال الإمام الحسين: (إلهي رضاً برضاك). فقد فعلَ ذلكَ الإمام الحسين يومَ العاشر من مُحرَّم وقال بعدما ذبحوا ابنهُ الرَّضيع عبد الله وألقى بدمه إلى السماء وقالَ: إلهي إنَّ الأمرَ سَيَهُونُ عليَّ لأنهُ في سبيلك.
وتُعلمنا ثورة الحسين أنَّ شيوخاً طاعنينَ في السن مثلَ حبيب بن مظاهر التسعيني حيثُ كانَ شدَّ حاجبيه بعصابةٍ شدَّت رأسهُ لأنَّ الحاجبين كانا يسقطان على العين فيمنعانهِ من رؤية حملَ السلاحَ دفاعاً عن الإمام واسُتشهدَ بينَ يدي الإمام الحسين، لأنَّ الأعداءَ لا يستطيعون الوقوفَ بوجه هذه الثقافة. الثقافة التي تُقدمُ قرابيناً في سبيل العقيدة من الطفل الرضيع إلى الشيخ التسعيني وتعتبر هذا من أصول المقاومة. حتى لم يمنع الإمام سَبيُ أهل بيته ولم يردعهُ قَولِ الحق والثورة على الطغيان من أسر حرائره وبناته وزوجته حتى قيلَ له: سيدي! إنَّ نسائكَ ستُسبى وربما كشفوا عَنْهُنَّ الحجاب ربما تعاملوا مَعَهُنَّ كالجواري. فيقول: لا، لا يمنعُ ذلك، ولا عيبَ في الأمر لأنهُ في ذات الله. تُرى هل يستطيع أحدٌ مُجاراة هذه الثقافة؟
ولذلك ينبغي للطغاة وحُكام الترهيب والترغيب للظلمة والمستكبرين الخوف والهلع من هذه الثقافة، وينبغي لهم أن يفتحوا المياه على قبر صاحب هذه المدرسة الثورية ثمَ يأتونَ لمواجهة ثقافة الجهاد والشهادة وعاشوراء ولن يبقى لهم طريقٌ آخر، لأنَّ هذه الثقافة ستقضي على الظلم والظالمين ولن يستطيعَ أحدٌ الوقوفَ بوجه ثقافة عاشوراء.
ظاهرة التطبير
إنَّ مجرد إحياء ذكرى عاشوراء من كُلِّ عام حيثُ تُعبِّرُ جماهير الأمة عن حزنها فهذا يعني الخزيَ والعارَ للظَلَمَة، وأنَّ البكاءَ في ذكرى الإمام يَضعُ مشروعية الحكام أمامَ التساؤل. وعلى مَرّ التاريخ قامَ البعضُ ومن أجل إظهار المقاومة أمامَ الطغاة مُقابل التهديد بقطع الأطراف في حال التوجّه إلى زيارة الحسين، وقاموا بضرب رؤوسهم بالسيف والقول للطغاة بماذا تُخيفوننا؟ من الدماء؟ فنحنُ مستعدونَ لفعل ذلك بأيدينا ماذا تُريدونَ بعدَ ذلك؟
بالطبع ذكرتُ ذلك في سياق الرد التاريخي ولم أتحدث عن الموضوع في سياق التأييد لهذه الظاهرة، بل أردتُ الإشارة إلى ردود الأفعال التي برزت من قبل الشيعة مقابل ظلم حُكام الجور، وللأسف تمَّ تحريف هذه المسألة بمرور الأزمنة وأصبحت قضيةٌ مُفرطةٌ وخُرافية وقد استَغلَّ الأعداء هذه الظاهرة رويداً رويداً و فقدت ظاهرة التطبير فلسفتها الوجودية. وليسَت هناكَ أيةُ روايةٍ تدعوا لضرب الصدور أو الرؤوس، وكلُّ ذلك عملٌ أوجدهُ الشيعة بمرور الزمن، لأنَّ هذا الموضوع يُمارسُ من أجل الذكرى وضرب النفس سواءً بواسطة اليد أو سلاسل الحديد، وكلُّ ذلك يعود إلى الأزمنة التي كان حكام الجور يُهددونَ الشيعة في مسألة زيارة الحسين واستذكار واقعة الطف، فكانَ ضربُ السلاسل على سبيل المثال لمواجهة التهديد بالجَلْدِ من قبل الحكام لكل من يريد زيارة قبر الحسين عليه السلام.
ورويداً رويداً تحولت هذه المظاهر إلى آدابٍ وتقاليد. لا أريد هنا القول إنَّ الكثير من هذه العادات كانت ثورية وكانت في الحقيقة نوعاً من اتخاذ الموقف ضدَّ الظلم والجور، وبعدها تحولت إلى عادات ٍوآدابٍ اجتماعية ٍ وثقافيةٍ وتمَّ تناسي فلسفتها وتحولت شيئاً فشيئاً إلى موضوعٍ خُرافيٍّ وأمرٍ غيرِ هادف، وتُصبحُ هيَّ في حدِّ ذاتها مانعاً مثلَ ربطِ الكلاليبِ والأقفال وتعليقها في منطقة الصدر وضرب الرؤوس بالسيوف والتي يتمُّ القيام بها في بعض الأماكن.
لقد فقدت أسبابها ومصداقيتها لكن البكاء وإقامة مجالس العزاء ولطم الصدور وإظهار حالة الحزن، وإظهار الفاجعة التاريخية من قبل أتباع مذهب أهل البيت كلُّ هذه تُريدُ إيصالَ رسالةٍ مُفادُها: أننا ورغمَ مرورِ نحوِ 1400 عامٍ من هذه الحادثة الأليمة ما نزالُ نشعرُ بالعزاء، وأنَّ الدماء التي أُريقَتْ في تلكَ الفترة من التاريخ ما زالت ماثلةً في أذهانِنا.
كلُّ يومٍ عاشوراء
في أحد الاجتماعات كانَ أحدُ الأساتذة الأوروبيين ولم يكن مُلمَّاً ببعض الأمور المذهبية، كان قد شاهدَ عبرَ التلفاز الإيراني مراسم عاشوراء على مدى يومين بعدها قالَ: ترى ما الذي حصل؟ فقيل له: إنها مراسمُ عزاءٍ لأحدِ قادة الشيعة قتلوهُ وأسروا أهلَ بيتهِ وعياله فقالَ: متى وقعت هذه الحادثة؟ لم نسمع فيها بالأخبار؟ فقالوا له إنها وقعت قبلَ 1400 عامٍ خَلَت، فتساءلَ: ولمَ البكاء عليه بهذه الحرارة؟ وأنتم تقولونَ إنَّ الحادثة قد وقعت قبل أكثرَ من ألف عام؟
بعدها أضافَ أنَّ طريقةَ بُكائكم هذه تُشيرُ إلى أنَّ الرجلَ قُتِلَ للتو! فردُّوا عليه بالقول: نعم. لقد أريقَ دمُ الحسين عليه السلام بالنسبة لنا كيوم أمس ولن يلعبَ عنصر الزمان والمكان دوراً مهماً في هذه القضية لأنَّ مُناشدةَ العدل والحقيقة لا تعرف الزمان والمكان وليسَ مهماً متى أُريقَ هذا الدم. المهم أنَّ هذا الدم الطاهر أُريقَ وهذا هو المهم بالنسبة لنا. فتعجبَ كثيراً لكلِ ما يرى من اهتمامٍ بذكرى شهادة الإمام، وكيفَ يبكي الإنسانُ مأساة الحسين عليه السلام بعدَ كُلِّ هذه الفترة الزمنية الطويلة وكأنَّ الإمامَ قُتِلَ بالأمس.
معنى السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام
إنَّ تُربةُ الحسين بالنسبة لنا عزيزةٌ للغاية وهيَ من حيثُ كونها تربةً لا تفرق عن سائر أنواع التربة ولا فرقَ بينها وباقي تُربة العراق، لكن يُقالُ إنَّ السجودَ على تربة الحسين أكثرُ ثواباً. تُرى لماذا؟ وما هو الفرق بين تربة الحسين وتربة الكوفة أو البصرة أو تربة الحجاز أو همدان أو أيَّةِ ذرةِ ترابٍ في الرَّي أو أي مكانٍ آخر؟
يأتيكَ الجواب: إنَّ الفرقَ يكمن في أنَّ هذه الأرضَ والإنسان والتاريخَ شَهِدَ ملحمةً لم تُسجل في كل التاريخ ملحمةٌ مثلها. ربما كانت الأحداث التاريخية مهمة، لكن أي منها لا يرقى إلى حادثة الطف وأهميتها وعليه فإنَّ السجودَ على تربة الحسين في الصلاة تفرق عن السجود بغيرها، لأنَّ الإنسانَ في تلكَ السجدة عليه أن يلتزمَ عملياً بأسباب ذلك، وأحدُ هذه اللوازم العملية السجود لله سبحانه ومن ثُمَّ التوحيد، وهناك عملية أخرى يتمُّ تناسيها في المجتمع الإسلامي، ألا وهيَ الاستعداد للتضحية في سبيل هذه الأصول.
إنَّ السجدة على تربة الحسين تُذكرنا دوماً أنَّ هذه السجدة هي حركة توحيدية، وهيَ بغض النظر عن الفداء و الإيثار والاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس والاستعداد للموت، وألا يوجد شيء مُهماً بالنسبة (للإنسان)، أي ألَّا يكونَ أي شيءٍ عائقاً أمامَ التضحية بالروح والمال والعيال والحياة والجار والشخصية والاعتبار، وأن يكون على استعدادٍ لفقد أي شيءٍ من الوثائق والعمل، وأن يكونَ مُسلِّماً بكل شيء. هذا هوَ معنى السجدة على تربة الحسين. أي أنَّ التوحيدَ يرتبطُ بالولاية والعدالة لأنَّ السجود على تربة الحسين تختلف مع السجود على باقي التراب، لأنها توصل التوحيد بالولاية والعدل وتوصل بينَ الإنسان والجهاد والشهادة، وهذا ما يتم ُّمواجهته ومحاولة منعه.
الحذر من الغلاة والمغالين
ومن جهةٍ أخرى ينبغي أن نقفَ أمامَ الثقافة الخرافية التي يتمُّ طرحها في المجالس الحسينية، والمدائح والإسراف في ذكر الدم وضرب رؤوس الأطفال الرُّضَّع بالسيوف على رؤوسهم باسم عبدالله الرضيع، وضرب السيوف من قبل الكبار لِأنفسهم. إنها أمورٌ غيرُ واردة. حتى مسألةُ ضرب الظهر بالسلاسل ولطم الصدور، لن تَجدَ ذِكراً لها في الروايات.
الروايات تُشيرُ إلى إحياء ذكرى الحسين والبكاء في ذكرى استشهاده، وما عدَا ذلكَ فهيَ حركاتٌ رمزية أوجدها الشيعة أو الإيرانيونَ على وجه الخصوص وهي جميلة للغاية، حيثُ ترى الملايين ينزِلونَ إلى الشوارع ويذرفونَ الدموع ويلطمونَ الصدور في مراسم خاصة كأنَّ ظهر اليوم العاشر من مُحرَّم هوَ ذاكَ يومُ الواقعةِ في كربلاء. ورغم ذلك علينا أن نكونَ حذِرينَ ويقِظين ألا تخرج هذه المراسم عن المفاهيم الإسلامية والقيَّمة والأحكام الإسلامية، وتتبدل إلى قضايا حمقاء خُرافية وكاذبة أحياناً، فيها المُبالغة والغلو، لأنَّ الإمام الحسين عليه السلام وسائر الأئمة نُقِلَ عنهم القول إنَّ المغالين غيرُ مؤمنين، أي من يقولُ إنَّ الأئمةَ هم أعلى مرتبة ودرجة من الأنبياء، وفي بعض الأحيان يوصلونَ مرتبتهم إلى مرتبة الله سبحانه، فهؤلاء ليسوا بمسلمين، والأئمة منهم بُراء، حتى إنَّ حُكمَ الاعدام نُفِّذَ ضدَّ مجموعة من المغالين كانوا في زمن خلافة الإمام عليٍّ عليه السلام، وكانَ هؤلاء يؤلِّهونَ الإمام عليّ عليه السلام، وكانَ الإمام يُعاني من أعدائه ومن هؤلاء أيضاً.
في غزوة الخندق على ما أتصور، ذَكَرَ الرسول صلى الله عليه وآله إنني أعلمُ أشياءَ من عليّ لو بُحتُ بها لقيلَ في حقهِ ما قيلَ في عيسى بن مريم ولكانَ نُعِتَ بالألوهية، ولكانَ الناسُ جمعوا التُراب الذي تحت قدميه تبرُّكاً، لأنَّ النبي كانَ يخشى أن يتمَّ التعامل مع الإمام بعدَ وفاته بهذه الطريقة. ولكن شاهدنا في التاريخ كيفَ تمَّ التعامل معه.
وهناكَ روايةٌ عجيبة، حيثُ يُروى أنَّ الإمامَ كانَ مع جماعةٍ من أصحابه يمرونَ أمام موضعٍ ما، فلاحظَ أنَّ جمعاً تسمَّروا في الطريق، وظلَّوا يُعاينونَ الإمامَ بطريقة العاشق الولهان وكالعبد الذي يرى مولاه، فرجعَ الإمام ونَظَرَ فإذا هم يهمسونَ بكلامٍ بشفاههم ويقولون: أنت، أنت، أنت. ففهمَ الإمامُ ما يقولون لأنَّهُ كانَ قد أخبر بوجود مثل هؤلاء وكانوا من الغلاة. وقال َ لهم: ما بكم لعنكم الله، فقالوا له أنت الرَّب، أنتَ الإله، قالوا: أنتَ أعلى مرتبةً من المسيح ابن الله، وهناك تقول الرواية إنَّ الإمام نَزَلَ من الفرس وسَجَدَ لله و ذرَفَ الدموع واستغفرَ لهؤلاء وقالَ: إلهي أنتَ تعلمُ تنفُّري مما يقولون، إنني عبدُك ولا أرضى بما يصفوني، وأنتَ جلَّت قدرتك تعلمُ صدقي، فنهضَ وكفكفَ دموعهُ وقال: أظنُّ أنكم لا تقصدونَ ما تقولون. فَردُّوا: لا بل نقصد فأنتَ الرب. فقال: استغفروا وارجعوا إلى رشدكم، وبخلافه سآمرُ بقتلكم. فقالوا: اقتلنا. لا نعودُ عن كلامنا.
فأمرَ الإمام بحفر خندقٍ وإلقاء الحطب فيه، وحفروا حفرةً إلى جواره وفتحوا قناةً فيما بينهما، وأشعلوا النارَ في الحفرة، وأغلقوا الفوهة وألقوا المغالين في الخندق، واختنقوا وماتوا جميعاً. ثمَّ جاء البعض وقال للإمام: لم فعلت ذلك يا سيدي؟ كانوا من المُريدينَ لكم! لقد كانوا يعشقونك! فَردَّ الإمام: لقد انحرفوا عن التوحيد باسم علي، ولا يهم إن فعلوا ذلك باسم عليٍّ أو ضدهُ، فهم خانوا، وعليه ينبغي معاقبة الخائنين، ولو لم يفعل الإمام ذلك لكان خرج البعضُ بعد حياة الإمام ليقولَ: لقد ألَّهوا الإمام وتغاضى هو عن ذلك، وقالَ: حسناً لست إلهاً ولكن سأصفحُ عنكم. ولو لم يفعل الإمام هذا بالمغالين، لم يكن ليبقى من الإسلام في يومنا هذا شيءٌ ألبته. لقد رأى الإمام أنَّ الإسلامَ كُلَّهُ والبشرية والتاريخَ تقف في كفَّة، وهؤلاء المغالونَ العشرة أو العشرون في كفَّةٍ أخرى، وأنَّ ما يقولونهُ ارتدادٌ عن الدين لذلكَ عالَجَهُمْ بما ينبغي.
لقد كانَ هدفُ الإمام القضاء على الإلحاد والانحراف والمؤامرة، سألَ البعضُ لماذا يُحكم المُرتَدُّ بالإعدام؟ بالطبع لا نعني بالمرتد من يسأل أو يستفسر أو يشك أو يجهل، فلا يصدق على هذا إطلاقاً اسم المرتد مثلما يتصور البعضُ خطأً، فهؤلاء مُستضعفونَ في أفكارهم. المُرتد هو من يفهم ماذا يقول وماذا يفعل، فهوَ مُتأمرٌ على الإسلام وعليه إنَّ من يفعل شيئاً خارجَ إطار الجهلِ فإنهُ مُرتدٌ وينبغي إصدار العقوبة ضده.
وينظر الإسلام إلى الارتداد على أنه الوقوفُ العلني والصريح وعن سبق إصرار وتصميم ضدَّ الدين ومفهوم التوحيد وهو بمثابة القتل المعنوي، أي ارتكاب المجزرة المعنوية العامة وغَلق الطريق أمامَ كُل عطشى المعرفة والروحانيات، أي خداع المؤمنين.
المرتد يقول في حقيقة الأمر إنَّ الأنبياء جميعاً كذَّابون، وإنَّ كُلَّ الأنبياء من أوَّلِهم إلى آخرِهِم مُبتَدِعُون، وأنَّ البشرية خُدِعت بوجود هؤلاء وتضحياتهم وجهادهم وتحمُّلهِم الصِّعابَ والسجنَ والنفي والجوع والتعذيب والقتل. وإنَّ كُلَّ هؤلاء كانوا من الحمقى، وعليه يتقاطع الارتداد والمغالاة في بعض المواطن.
بعض النظريات التي طرحت حول واقعة الطف
هنا أودُّ الإشارة إلى بعض النظريات المطروحة حولَ عاشوراء، بعضها طُرحَ قبلَ الثورة، وبعضها الآخر بعدَ الثورة، أي خلال النّصف القرن المنصرم في محافل ما يُصطَلَحُ عليهم بالمتنورين في داخل إيران، ربما كانَ البعضُ من طلبة جامعة شريف الصناعية التكنولوجية قبلَ الثورة يتذكرونَ ما كانَ يُطرحُ في الجامعات ولا أريدُ تحديداً ذِكرَ أينَ طُرحت هذه المقولات، حيثُ كانت هنالك عدَّةُ رؤىً في طرح قضية عاشوراء.
كانَ البعضُ ينظر إلى واقعة الطف ومسألة عاشوراء على أنها أسطورةٌ تاريخية دينية عرفية، وكانوا لا يتطرقونَ إلى تفاصيل واقعة الطف وأسبابها وهذا يُعدُّ في حقيقة الأمر تحريفاً وانحرافاً في تفسير قضية عاشوراء وقالوا: إنهُ ليسَ هنالكَ حكمةٌ في قضية عاشوراء لا من الناحية العقلانية ولا من الناحية الاجتماعية أو السياسية ولا تتضمنُ المطالبة بالعدل والقضية تتجلى في الفديَة، وهي الموضوع الذي طَرَحهُ المسيحيونَ بخصوص المسيح عيسى بن مريم، من أنَّه ابن الله نَزَلَ إلى الأرض على هيئة إنسانٍ كي يُفدى به لمسح الذنب الأول للبشر. الذنب الذي قامَ به أبونا آدم عليه السلام، لأنَّ الكنيسة تقول: إنَّ جميعَ البشر يولدونَ كافرينَ ونَجِسِينَ وخُبثاء، وعليه ينبغي غَسلُهُم غُسلَ التعميد. وهكذا جاءَ عيسى المسيح ابنُ الله إلى الأرض كي يتمَّ الفداء به ويُصلبَ لتكونَ روحهُ فداءً للبشرية جمعاء، لمحو ذنب آدمَ من على عاتق البشرية.
وهناكَ تغيراتٌ وقراءاتٌ مختلفة في المذهب المسيحي، منها قضية الفِداء وقضية العشاء الرباني وقضية الماء والشراب والخبز الذي نأكلهُ وهو لحم ودم عيسى. والقضايا التي تطرحها المذاهب المسيحية حولَ هذه القضية، وهيَ تتعارض مع بعضها، وهكذا يقولون إنَّ الحسين كانَ يعلم بالأمر، وإنَّ قضيةَ الإمام ليست أمراً بالمعروف ونهياً عن المُنكر والعدالة والحكومة وكلاماً من هذا القبيل، إنها قضية الفدية، أي أنَّ الحسين هوَ تكرارٌ لقضية المسيح، وقد طُرِحَ هذا الرأيُ مؤخَّراً في إحدى الجامعات الأمريكية من قبل أحد الأساتذة الغربيين. حيثُ يتخصصُ هذا الأستاذ بتدريس الكلام المسيحي.
وقد التقيتُ بهذا الأستاذ في إحدى الندوات وعَرَفَ أنني قادم من إيران وأنني من المذهب الشيعي، فقال لي هناكَ اشتراكٌ بيننا ونقطة تفاهمٍ يمكن أن نؤسِّسَ من خلالها الحوار بينَ الطرفين، وهي قضية الحسين وعاشوراء، فقلتُ وكيفَ ذلك؟ فقال: إنكم تقولونَ في الحسين ما نقوله في المسيح، فأنتم تقولونَ إنَّ الحسين ضحَّى بنفسه وباتَ فديةً، ونحنُ نقولُ ذات الشيء بالنسبة إلى المسيح.
فقلتُ هذا ليسَ صحيحاً، نحنُ لا نقولَ هذا في الحسين. فقالَ: ألا تؤمنونَ بأنَّ الحسين كانَ مُرسلاً من قبل الله ليُضحّي بنفسه في عاشوراء كي يتمَّ غسل ذنوب البشرية؟ قلتُ: لا، لا نقولُ بهذا. فقلتُ له هناكَ نقطةٌ جيدة لبدء الحوار معكم، ولكن ليسَ هناكَ مجالٌ للتفاهم مع بعضنا، وبتصوّري أنَّ الموضوعَ يختلف، ولكن لا بأس كي نبدأَ بالتحاور.
إنَّ ثقافةَ هذا المسيحي هيَ ذاتها ثقافة القرون الوسطى لم تتغير، وكذلكَ الحالُ بالنسبة إلى ثقافات وحتى المدارس المسيحية الجديدة في الكلام المسيحي، واليهودية وأدعياء التنوير الديني من النوع المسيحي تراهم جميعاً يُكررونَ اليومَ هذه المقولة، على سبيل المثال ماذا يقول الوجوديون؟
الوجوديونَ المسيحيونَ أمثالُ: كيركيجارد، والآخرون يقولون إنَّ الإيمان حالةٌ من القفز في الظلام، هذا هوَ قيمةُ الإيمان في نفوسهم، أي أنَّ الإيمان في اعتقادهم نفيٌ للعقل. وللأسف فإنَّ بعضهم يقولونَ بهذا المبدأ في أوساط المسلمينَ أيضاً. حتى أنني رأيتُ أنَّ بعضَ خطباء المنبر الحسيني يقولون ما يذهب إليه الغربيون.
أقولُ إنَّ الأمر ليسَ كذلك، إنَّ الاعتقاد السائد لدى الشيعة أنَّ عاشوراء تجسيمٌ للعشق الإلهي بقدر ما هيَ تجسيمٌ للعقل، وأنَّ طريقَ كربلاء ذو مبنىً عُقلائيّ وأنَّ العشقَ هو استمرارٌ وتكميلٌ للعقل، لا نفي َ للعقل. نعم ربما كانَ في ثقافة الإسلام والشيعة ذِكرٌ للموضوع من الناحية المجازية والشاعرية حيثُ ترى بعضَ الوعَّاظ يقولونَ إننا مجانین في حُبَّ الحسين، أو أنَّ حُبَّ الحسين أجنني، وأن لا عقلَ لنا نحنُ عُشاق الحسين، فإن كانَ هذا الكلام حسِّياً فلا بأسَ في ذلك. وتارةً لو أردتم بحثَ الموضوع من الناحية العقلية والمحاسبات المادية والتجارية، فإنَّ واقعة الطف وعاشوراء لم تكن بالحساب المادي رابحة، ولم تكن عقلانية لأنَّ الإمام لم يكن يقصد النَّفعَ الشخصي فيها، فهيَ ليست من أجل النفس والنفسانية والانا.
إنَّ العقلية الدارجة في الثقافة الليبرالية الغربية اليوم عقلية رأسمالية، وهيَ ليست عقلانية بالمعنى الحرفي للكلمة، إنها نفسانية والأنا والسلطة والاستكبار أي أنَّ كُلَّ العالم هو فداءٌ لي، وأنَّ كُلَّ شيءٍ هو لي، إنني مركز هذا العالم، وأنَّ حقوقي فوقَ حقوق الآخرين، وكذا مصالحي تفوقُ مصالح الآخرين، وأنَّ القيم والأخلاق والدين والوحيَ أمُورٌ نسبية. وأنني أنا المُطلق والآخرونَ نسبيّون، والكلُّ مشكوكٌ بهم، وأنا القطعيُّ في كُلِّ هؤلاء، وأنَّ اللّذة والربحية والتجربة عندي واقعيَّة، وأنني أقف في مركز الحياة والفلسفة والباقي عبارةٌ عن زَبَدْ، ويمكن قرآءةُ ألفِ موضوعٍ من الموضوع الواحد. ولكن هناكَ قرآءةٌ واحدة للمصالح التي أتحدث عنها وهيَ التي أنطقُ بها لا غيري، هذا باختصار الثقافة الأمريكية الصهيونية، هذا ما يُرددهُ الإنجليز والأمِريكيانَ والصهاينة في عالمنا اليوم. وعندما يكون الكلام عن الإسلام وعن القيم الإسلامية فإنَّ كُلُ شيءٍ يكون نسبياً ومشكوكاً به، وتكون القراءاتُ مختلفة، وعندما يكون الحديث عن المصالح التي يتحدثونَ عنها تكونُ هناكَ قراءةٌ واحدةٌ وفهمٌ واحد، ولا حديثَ عن شكوكٍ أو نسبية، وأنَّ كُلَّ شيءٍ مُطلقٌ وواضح كما نقول نحن، وينبغي أن يكونَ فِكرُنا عالمياً، أليسَ هذا المنطقُ جميلاً؟
إذن فالعقلانية الحقيقية موجودة في عاشوراء، وهناكَ عقلٌ بمقدار العشق، ولو كانَ المرادُ من العقل حساب النفعية الفردية فليسَ هناكَ عقلانية في الموضوع، أي أن يقومَ رجلٌ يصطحبُ معه سبعينَ رجلاً وامرأة وطفلاً ويقف في مواجهة أشخاصٍ يعرفُ حقَّ المعرفة أنَّهم سيقتُلُونَهْ فهذا جنونٌ ما بعدهُ جنون، ولا عقلانية في هذا الموضوع أبداً. وإذا كانَ المُرادُ من العقلانية أن أعيشَ بأيّ قيمة لِأكُلَ وأشرب فإن كان معنى الحياة من أجل العناية بالأجساد والأكل والنوم فهذا خلافٌ لهذا النوع من العقل.
أما العقل بمعناه الحقيقي فهوَ أن يقومَ الإنسانُ بعملٍ تكونُ فيه المنفعة أكثر من الضرر، لتصوّرنا أنهُ تمت مُراعاةُ العقلانية في عاشوراء، بمعنى أنَّ الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه انتفعوا أكثرَ مما تضرَّروا، ولِذا فإنَّ عملهم كانَ عقلانياً، لأنهم تحمَّلوا يوماً أو نصفَ يومٍ من الاشتباك واشتروا لأنفسهم الخُلد. ولِذا فإنَّ شُهدائنا هم الذينَ ذهبوا مشياً على حقول الألغام، وهم الذينَ اشتبكوا مع العدو، وهم الذينَ تحمَّلوا التعذيبَ في سجون الطواغيت، لم يكن هؤلاء مجانين بل ينبغي القول إنَّ هؤلاء حَسَبوا حِسابهم بصورةٍ جيدة، وكانَ حِسابهم كِحساب السوق، فإنهم قالوا مع أنفسهم لنتحمَّل التعذيب أو نُصابَ بالشظايا نُصبحُ بعدها مُعاقين نتحمَّلُ الأذى لِثلاثينَ أو أربعينَ عاماً بعدَها نُخلَّد ونَحصُلَ على الجنَّة التي وعدنا بها الرَّب، فهل خَسِرَ هؤلاء أم ربحوا؟
إنَّ من يقول إنَّ هؤلاء تَضرَّروا فإنه يُنكِرُ العلاقة مع ما وراء الطبيعة، فهوَ يتصوَّر أنَّ الأمرَ يتجلَّى في عالَم اليوم وحسب، وعلى هذا فإنَّ من ينظر إلى هذا الموضوع من هذه الطريقة تكون الدنيا له كالإصطبل، فمن أكَلَ أكثر انتفع، ومن ضَرَبَ الآخرينَ ومنعهم من الأكل وأكلَ حصتهم فهوَ الرابح الأكبر.
ثمَّ إنَّ هذا التفسير يقودُنا إلى القول إنَّ كُلَّ شُهداء التاريخ هم مجانين وكلُّ مُجاهدي التاريخ بلهاء، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأنَّ الإسلام يقول إنَّ الحياة عبارةٌ عن ممرٍّ إلى الآخرة وإلى الحالة الأبديَّة، أمَّا نحنُ فقد قضينا الشطر الأوفرَ من العُمر، الشطرَ الأحلى، وما سيأتي هوَ عبارةٌ عن النصف الثاني من العمر الذي لن يكونَ في حلاوة النصف الأول، فهل أنَّ الإنسان الذي تنتهي حياتهُ كما جرى على الحسين خَسِرَ في المُعادلة؟ ولم تكن خطوتهُ مواكَبَةً للعقلانية؟ بتصوري فإنَّ مثلَ هذا التفسير تفسيرٌ خاطئ.
وهناكَ رأيٌّ آخرَ يقولُ: إننا نقومُ بالمشاركة في العزاء بُغيةَ العبادة والتقرُّب إلى الله والحصول على الثواب الأخروي، ولا علاقة لنا في الحكمة الموجودة في عاشوراء. وهذا أيضاً رأيٌّ مُنحَرِفٌ. وعندما يسألُ أصحاب هذا الفكر عن واقعة عاشوراء يقولون لك: لقد كانت واقعة الطف عبارةً عن حرب عصاباتٍ خَسِرَ فيها معسكر الحسين، لقد كانَ الحسين كجيفارا انْتَفَضَ ضدَّ الظلم، لقد كانت حِساباتهُ سياسيةً وماديَّةً وتوسُّعيَّة، وهكذا يُحوِّلونَ الحسين عليه السلام إلى ثوريٍّ ينتفضُ ضدَّ حكومات الظلم ويُقْتَلْ.
لقد كانَ هذا النوع من الفكر رائِجاً قبلَ انتصار الثورة وبدايتها، وذلكَ عندما كانَ الناسُ متأثرين بالثقافة الماركسية خاصةً الفدائية منها، وكانَ جزءٌ من أدب التنوير الديني الخاطئ لا التنوير الديني الصحيح قبلَ الثورة، خليطاً من ثقافةٍ محلِّيَةٍ إسلامية وثقافةٌ غربية.
يقولُ هذا الرأي إنَّ عاشوراء كانت عبارةً عن دماءٍ وجهادٍ سياسيٍّ وأمثال ذلك، هذا ظاهرُ عاشوراء، أمَّا باطنهُا فلم يكن كذلك، إنَّ أصلَ عاشوراء هو حالةٌ من العرفان. لقد كانَ أصل ُعاشوراءَ روحانياً وتَقرُّباً إلى الله، وأداءً للواجب الإلهي، وكانَ من أجل الشريعة وكانَ هذا جُزءً من الثورة الحُسينية. لم يكن الإمام سياسياً في كربلاء وحَسب، كما لم يكن أسطورةً وعبادة. لقد كانَ الإمام الإثنين معاً.
وهذا إفراطٌ من نوعٍ آخر، فإفراطٌ يقول أنّه ليست هناكَ أيَّةُ علاقةٍ بينَ عاشوراء وكربلاء من جهةٍ مع عالَم الواقع والسياسة والعدالة والحكومة، وأن لا علاقة للإسلام بالحكومة، ولا علاقة لِعاشوراء بالحكم، وأنَّ الحسينَ عليه السلام لم يرد أصلاً الحكومة الإسلامية، وأنَّ الحسينَ أرادَ هكذا أن يموتَ، كي يجلسوا ويندبوا قَتْلَه.
وهناكَ من يقولُ إنَّ الحسين قُتِلَ من أجل السياسة وإقامة الحكومة الخاصة به، وهم في ذلك ينسونَ الأمورَ الروحانية والتقوى والعشق والآخرة والقيم الإلهية والدينَ، أي أنَّ الحسين كانَ مُناضِلاً وحَسب، أي أنَّ الإسلامَ يتجلى في السياسة. أمَّا القضايا الاجتماعية والروحانية والأخلاق والتقوى والعرفان لا علاقة لها بالإسلام وهذان المسيران مُنحَرِفان.
أمَّا الثالث فيربطُ الحسين بالفكر المسيحي، وأمَّا الثاني فهوَ الحسين المُناضل دونَ روحانياتٍ أو اندفاعٍ ديني ودونما توحيدٍ ومَعَادْ. في حين أننا نرى أنَّ الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه عاشوا لحظات عاشوراء والتاسع من مُحرَّم في أجواءٍ مُفعَمةٍ بالروحانية والتقوى والعبادة والتقرب إلى الله وكُلَّ ما نقولُ عنهم كانَ كلاماً حولَ الأجر الإلهي.
وفي ذات الوقت تحدَّثَ الإمام عن العدالة والسياسة والحكومة وحقوق الإنسان والتكليف. وهناكَ قِراءةٌ أُخرى في الحسين والذي يبدو فيها ديموقراطياً هنا، هذه من الطُروحات التي جاءت بعدَ انتصار الثورة، ومازالَ بعضُ مُروِّجي هذه الأفكار يطرحونها. إنهم يقولونَ هل تعلم لماذا ذهبَ الإمام الحسين إلى كربلاء والكوفة؟ فهوَ لم يُرِدْ أن يُقتَلْ، وهوَ لم يدري أنه سيُقْتَل، وهنا يُنكِرونَ عِلمَ الإمامة، في حين أنه هناك الكثير من الروايات تقول إنَّ الإمام الحسين عليه السلام عندما ولِدَ بَكَاهُ الرسول، وكانَ أوَّلَ من بكى الإمام الحسين عليه السلام، وفي الرواية أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله عندما بكى، سأَلَته فاطمة سلام الله عليها: مما بُكاؤكَ يا أبَتاه؟ فقال: إنني أرى مَصْرَعهُ حيثُ يتقلبُ في لُجِّهِ من الدماء، إنني أرى ذلكَ الآن.
الإسلام والديموقراطية
وهذا الطيف الثالث يدَّعي أنَّ الإمام لم يكن يعرف أنهُ سَيُقْتَلْ، إنَّ الرجُلَ كانَ ينوي العملَ وفقَ المبادئ الدّيمُقْراطية، بايَعَهُ الناس، وإنَّ أكثرية أهل الكوفة بايعوه، وعليه فإنَّ بإمكانهِ الرحيل إلى هناك من أجل تشكيل الحكومة، وعندَ وصُوله إلى كربلاء بالقرب من الكوفة، انقلبت الأوضاع ونَكَثَ الناسُ عن بيعتهم للحسين، وهنا يؤَاخْذهم على فعلتهم، ويقول لهم: لقد جئتُ إلى هنا لأنَّكم خاطبتموني، لماذا فعلتم بي هذا؟ ولهذا فإنَّ مشروعيتي قد سقطت، لأني قد أصبحتُ في أقليَّةٍ ويزيد وأعوانهُ في أكثريةٍ من أمرهم. هكذا تقول الديمقراطية، الحكمُ للأكثرية!
أليسَ كذلك؟ وعليه فإنَّ مجيئي إلى عاشوراء ليسَ ديمقراطياً، اسمحوا لي بالعودة. ولأنَّ الإمام يعلمُ أنَّ هؤلاء لن يسمحوا له بالعودة، دعا عليهم وقالَ: أدعو الله أن يُنزِّلَ عليكم العذاب في الدنيا والآخرة. لقد أعلنتم استعدادكم للحرب والجهاد، وإقامة حاكمية الإسلام ثُمَّ نكثتم. ولم يَقُلْ أنهُ لا يملكُ حقَّ الحاكمية، وعليه ونظراً لخيانتكم وعدم استحقاقكم لأن يكونَ الحُجَّةُ فوقَ رؤوسكم، فإنني سأعودُ من حيثُ أتيت. أرادَ الإمام أن یتم الحُجَّة علیهم.
وهذا حسينٌ على أساس القراءة الديمقراطية. عاشوراء على أساسٍ ليبرالي. وها هم اليومَ يكتبونَ في الصحف والمجلات عن الحسين الديمقراطي الذي يكتسب قيمتهُ من الديمقراطية، أي أنَّ الإسلامَ بحاجةٍ إلى تزكيةٍ من قبل الديمقراطية، حتى يكونَ ذا قيمة!
وهنا اسمحوا لي أن أقولَ إنَّ أصحاب المدرسة التي تقول إنَّ الإسلامَ يكسِبُ المشروعية من الديمقراطية ليسوا بمسلمين، ربما كانوا جهلةً أو أُميين، عليهم أن يعلموا أنَّ الإسلامَ ليسَ ما يقولون. إننا قبلنا الإسلام دونَ حاجةٍ لنا بالديمقراطية، وهل يَثْبُتُ التوحيد بواسطة الديمقراطية حتى نؤمنُ بها؟ وهل يمكن الوصول إلى القيمة والعدالة والمكانة من الديمقراطية؟ وهل يتمُّ أخذُ حقائق العالم وقيمتهِ من الديمقراطية؟ وهكذا بالنسبة إلى الفضيلة الأخلاقية والقيَّم. عليه ينبغي أخذُ القيمة للديمقراطية من الإسلام، وأن تأخذ الديمقراطية قيمتها واعتبارها من التوحيد والنّبوة والعقل والعدالة. وإذا وقفت الديمقراطيةُ مقابل التوحيد والعقل والعدالة، فإنَّ هذه الديمقراطية لا تعدِلُ عندنا وزنَ بعوضة.
إننا نقبلُ الديمقراطية في إطار الدين، في إطار التوحيد والنبوة، في إطار العدل والقيم والأخلاق. والديمقراطية التي تقف مُقابل القيَّمِ قلتُ لكم لا تعدِلُ عندنا وزنَ بعوضة، ولا فرقَ بينها وبينَ الاستبداد والظلم، وعليه فلا فرقَ بين الديمقراطية والاستبداد من هذه الناحية. ربما كانَ الظَّلمُ من قِبَلِ شخصٍ، وربما كانَ من قبل مجموعة باسم الديمقراطية، وربما كانَ من حزب.
والمسلم عبدُ الله لا عَبدَ الديكتاتور ولا عبدَ الديمقراطية وعليه فإننا نحترمُ الديمقراطية وحقَّ الحاكمية والمشروعية في إطار الإسلام ولا غير. وإذا ما اتفقَ في زمانٍ ما في التاريخ، إذا قررت أكثريةُ سكان الأرض بملياراتهم رفضَ التعاليم السماوية فإنَّنا لن نستسلم للديمقراطية، ونُركِنَ الإسلامَ جانباً، لأنَّ أكثريةَ العالم هم غيرُ مسلمين. ولكن ربما تقول إنَّ الإسلام سيكون قابلاً للتطبيقِ عندما تفهمه الأكثريةُ، وتقبل به، لكن ما العمل وقد رفضته الأكثرية وعارضتهُ؟ ومن خلال ذلكَ نتوصَّلُ إلى أنَّ الأمرَ غيرُ قابلٍ للتطبيق على الأرض، ليسَ لأنهُ لا اعتبارَ أو قيمةً لهُ، بل لأنهُ غيرُ قابلٍ للتطبيق مثل الكثير من الأمور، وهناك الكثير من الناس المرضى يحملونَ الوصفة الطبية، لكن لا إمكانية لِشراء الدواء من الناحية المادية، عليه يَتَوفَّى هؤلاء هذا لا يعني أنَّ الوصفة غيرُ مجدية، وعليه فإنَّ المريضَ يتوفَّى.
وهناك تعبيرٌ لطيفٌ جداً يقول: إنَّ المجتمع الذي رَفَضَ حكم الإمام علي عليه السلام، وأرْكَلَ الإمام لم يحرم الإمام علي من كونه عليَّا، بل حَرَمَ نفسهُ من مُصاحبة عليٍّ.
إنَّ المجتمع الذي رَفَضَ حُكمَ الإمام لمدة عشرين عام ونيّف، يليقُ به أن يكونَ طيّعاً لِأمثالِ معاوية ويزيد وبني أمية وبني العباس. إنَّ المجتمع الذي يكون على هذه الشاكلة، سيحرم نفسه من وجودِ عليٍّ لا محالة.
المصدر:رابطة الحوار الديني للوحدة